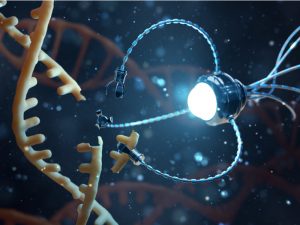شرد ذهني فجأة وأخذني إلى الوراء وذكَّرني بمواضيع كانت قد شغلت بالي كثيراً ولطالما تمنيت أن أكتب عنها في الماضي. حصل هذا عند قراءتي مقالاً للدكتور أحمد أبو زيد بعنوان «الثورة التكنولوجية الجديدة» في باب «مستقبليات» في مجلة «العربي» عدد آب 2003.
يذكر الدكتور في مقالته أن «العلماء في الغرب واليابان منشغلون بعلم جديد يعرف باسم النانوتكنولوجي، أي تكنولوجيا الأشياء الدقيقة والصغيرة للغاية، وتعني بلغة المقاييس جزء من المليار (وليس المليون) من المتر، وأن تلك التكنولوجيا ستُستخدم في مجالات عدة، منها أنه في وقت قريب جداً سوف يمكن زرع نوع من الرقائق النانوية (نسبة إلى كلمة نانو أي القزم باللغة اللاتينية) في اللحاء المخي لدى الأطفال، فيصبح الدماغ محمَّلاً بمختلف أنواع المعلومات التي يحتاج إليها الطفل في سنوات الدراسة، ويؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة العملية التعليمية لتقتصر على تفسير المعلومات المخزونة في عقل الطفل بدل الانشغال بحفظها واستيعابها كما يحدث الآن». انتهى الإقتباس.
وبكلمة أخرى سيتم التدخل في حكمة الخالق وتزويد أياً يكن بالذكاء والقدرات العقلية التي لم يشأ الخالق أن يمنحه إياها أصلاً، أي أنه اختراع قد يغيِّر من طبيعة البشر.
وبدأت أفكر كيف سيستقبل عالمنا نحن هذا الإختراع. واسترجعت الأمثلة المشابهة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها لأشهر أو سنوات، وتصورت الجدل الواسع الذي سيتسبَّب به هذا الموضوع بين رجال الدين بعضهم مع بعض من جهة، وبينهم وبين العلماء من جهة أخرى. تصورت الاتهامات التي سوف يطلقها بعضهم على علماء الغرب متهمين إياهم بالكفر المبين والتدخل فى مشيئة الخالق وتوجيه عقل الطفل ولاسيما أطفال العرب والمسلمين بغير ما أراد الله لهم، وأن هذه التكنولوجيا اخترعت أصلاً لغايات خبيثة موجهة إلينا لأسباب دينية أو لإفساد عاداتنا وتقاليدنا.
لم تكن تخيلاتي تلك مجرد شطحة خيال في ليلة صيف، بل قفزة في الاستنتاج واستباق للأحداث بالاستناد إلى ما شاهدته أو قرأته في السنوات الأربعين الماضية، منذ وعى عقلي الأحداث من حولي. من هذه الأحداث على سبيل المثال وليس الحصر، وأذكرها عشوائياً، نزول الإنسان على سطح القمر وما صاحب ذلك الحدث من استنكار واتهامات، أعجبها تدنيس الأميركيين أحد محرمات الخليقة، ناهيك بالاتهامات حول الإخلال بنظام الكون، وأن ذلك فاتحة لكوارث قادمة من غضب الله. ثم جاء الجدل حول أطفال الأنابيب. ولم يمض وقت طويل بعد على السجالات الطويلة الحامية التي جرت حول ولادة لويزا براون، طفلة الأنابيب الأولى، ووجوب أو عدم وجوب استخدام أسلوب تلقيح البويضات خارج الرحم.
كما سمعنا من آبائنا وأجدادنا عن اللعنات التي صبوها على من اخترع الجهاز الشيطاني المسمى المذياع، وكم من فتاوى التحريم صدرت في حق من يستخدمه أو من يستمع إليه حتى، ولم يكن حظ التلفزيون أقل من المذياع ونصيبه من الشتائم أقل، لما يتسبب به من إفساد للأجيال الصاعدة وتسفيه للأخلاق والقيم الاجتماعية. والإستنتاج من كل ذلك أننا هنا في العالم الثالث لم نستطع في أي حال منع أي من الإختراعات التي أتت من الغرب أو الشرق، ولم نفلح في تعديل بعضها بما يتناسب جوهرياً مع ما سميناه قيمنا الأصيلة. لقد أقمنا ندوات واجتماعات حضرها مئات العلماء والمتخصصين لبحث مختلف التطورات العلمية ومدى صلاحيتها لمجتمعاتنا، وحتى تلك الإختراعات التي استنكرناها ورفضناها سرعان ما أخذت مكانها بيننا بعد أقل من 20 سنة في أكثر الأحوال، وكل ما فعلناه أننا أجلنا عملية تسخير التكنولوجيا ومنجزاتها، وما تتمخض عنه العلوم السياسيَّة والاجتماعيَّة لمدد متفاوتة الطول، ولكنَّنا في نهاية المطاف نرضخ لها رضوخ الحملان.
وأحفاد من عارضوا فكرة وجود المذياع في بيوتهم لديهم الآن أكثر الأجهزة تطوراً وأغلاها ثمناً، والأمر نفسه ينطبق على التلفزيون. يجب أن نتعلم من دروس التاريخ وتطور الأحداث البعيدة والقريبة أنَّ أي مقاومة لابتكار جديد لن تجدي في أي حال في حجبه عن مجتمعاتنا. والمطلوب ليس الرفض الأعمى لهذا المبتكر أو ذاك بذرائع شتى، بل الاستعداد له أحسن استعداد للإفادة منه أشد الإفادة وبما يتناسب مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا، وإذا شئت بأقل الأضرار على معتقداتنا ومفاهيمنا (وبعضها وهمية). فنحن لا نستطيع الاستمتاع بأي تطور أو إزدهار بدون قبول قاعدة تغيير بعض ما في أنفسنا وما نشأنا عليه.
نشرت في جريدة «النهار» بتاريخ 5-11-2003
وببعض الاختصار في جريدة «القبس» بتاريخ 18-9-2003.
موضوع النانو تكنولوجي ليس جديداً عليَّ كمتابع للمعارف والعلوم الحديثة، بل إن هذه التقنية تشغل بالي كثيراً، ويقلقني أنها لا تزال بعيدة عن حياتنا في الشرق لا لشيء إلا لإقصاء البحث العلمي ورفضنا أحياناً للتكنولوجيا الآتية من الآخر الذي إما نجهله وإما نرفضه لأسباب غير منطقية.
لقد كتبت هذه المقالة التي تنطوي على دعوة إلى الاستفادة من كل ما يأتينا من تكنولوجيا غربية واستغلالها في شتى نواحي حياتنا، بعد غربلتها في «منخلنا» الذي ينبغي ألا يكون ناعماً ولا معقداً جداً، بل نجعله وسيلة ليمر منها المنتج الذي نرغب في تبنيه واستغلاله في خدمة العلم والتنمية التي نصبو إليها.
ولا يخفى علينا ـ لدى التعرض لهذه التكنولوجيا ـ النهضة التي حققتها دولة شرقية تتشابه في ظروفها مع ما نمر به، إنه النموذج الصيني الذي لم يبتكر الكثير من وسائل التكنولوجيا، بل استفاد مما ابتكره الغرب وطوره بحيث أصبحت المنتجات الصينية أقل كلفة وأكثر إغراقاً للأسواق…، ليتنا أيضاً نطور مقومات التكنولوجيا مثلما فعلت الصين.
إنني أعتقد، بل أكاد أجزم أن أسلوب التفكير الذي نتبنَّاه في نظرتنا إلى أمور الحياة وفلسفتها وإلى التطورات التي تجري حولنا ليست إيجابية أو موضوعية أبداً، فمن المؤسف أننا نرفض تكنولوجيا الآخرين، لسبب تافه هو الشك والريبة اللذان لا داعي لهما، ومن الممكن تحويلهما إلى الثقة الحذرة أو افتراض حسن النية الواعية وتسخير كل ما يأتينا من تكنولوجيا أو علوم من الخارج واستغلالها في شتى المجالات.
وبالنظر إلى التجربة الصينية نجد أن لها مثلما لدينا من الخصوصيات، لكنَّها لم تهدر وقتها في لعن الإمبريالية، بل جابهت الغرب بسلاحه نفسه وأسلوبه نفسه. ولم تخترع الصين الكثير من أدوات التكنولوجيا، بل أخذت ما كان في الغرب وطوَّرته بحيث أصبحت هذه المنتجات أقل كلفة وأكثر توزيعاً، حتى إن لم تكن بالجودة نفسها، فالمهم إنها وجدت الأسواق أمام منتجاتها. وأصبحت بذلك لاعباً أساسياً في الساحة الاقتصادية العالمية عوضاً عن الوقوف كمتفرج على هامشها.